[ad_1]
“الشهيق والزفير”.. الصراع الوجودي بين حُرية الشعر وكوابح المجتمع
عبد المنعم رمضان يعترف: قصيدة النثر الأكثر شكا والأقل زهوا.. حتى في شعريتها!
وسط الأجواء المُلبدة بغيوم فيروس كورونا المُرهق، حيث ينتشر الخوفُ من انحباس النَّفَس، تبرزُ قيمة “الشهيق والزفير” أكثر من أي وقتٍ مضى، باعتبار سلامة هذا الإجراء اللحظي جبل الجُودي الذي تركنُ إليه سفائنُ القلوب المُلتاعة، وتطمئن إلى أن هناك بقية من نعمة الحياة.
منذ عدة سنوات لم أكن لأتعرف على وجه الشاعر عبد المنعم رمضان، إذ لم أقرأ له غير عدة نصوص شعرية منثورة في مجلات وزارة الثقافة، وكذا علمتُ أنه الابن المُدلل لأدونيس في مصر، حتى تناقشتُ مع أستاذي الناقد الكبير أبو اليزيد الشرقاوي، فنصحني بقراءة أعماله أولًا، وأن أبدأ بكتابه: “متاهات الإسكافي”، وقد أضناني البحث عن هذا الكتاب حتى وجدته بصيغة البي دي إف، فقرأته عدة مرات، ثم التهمتُ أعماله الشعرية تباعًا؛ حتى كان اللقاء الأول الذي جمعني به في مقهاه الأثير بوسط البلد فتعجبتُ أن يكون هذا الرجل الهادئ الوقور هو الذي قدَّم اعترافاته الجريئة في متاهات الإسكافي، حتى إذا اطمأننتُ إليه علمتُ أنه سمتٌ خادعٌ، ضبابي، يحمل تحت الضلوع لهبًا مُستعرًا، وأجنحةً مُحلقةً في عوالمَ مُغايرةٍ وسماواتٍ بعيدةٍ، وأن هذا العقل مُجالدٌ، آبقٌ، لا يعرفُ التأطير أو التحجيم في مكانٍ واحدٍ ولا زمانٍ بعينه، ومن ثم أدركتُ مدى التصاق المكتوب بنفس الرجل وضميره، فهو يُلقي كلماته في فم الزمان دونما وجلٍ، ولا ينام منها على همٍّ وبلبال، كما يقول عبد الرحمن شكري.
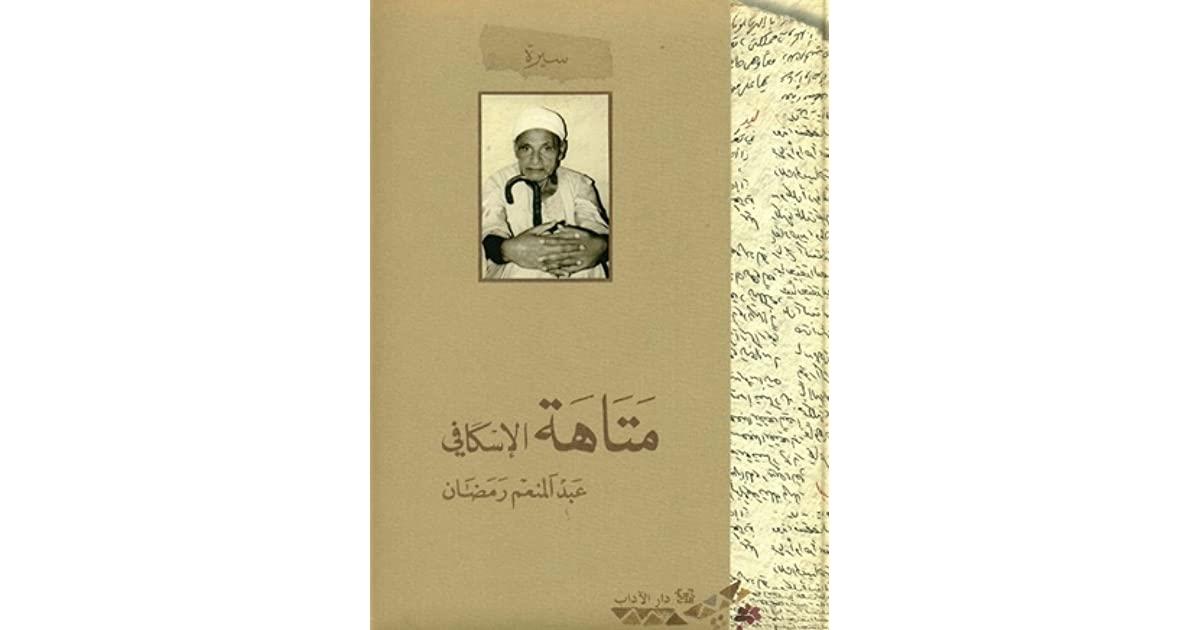
الخارج عن الصف
في مقدمتها للأعمال الكاملة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2014م، حاولت الكاتبة خالدة سعيد ضبط الحركة المُراوغة لقصيدة الشاعر عبد المنعم رمضان بقولها إنه: “شاعر يهوى اللعب الخطر، يخرج عن الصف ويغترب عن العائلة: عائلة الموروث، وعائلة الذكريات، وعائلة الأصول، وعائلة الصورة المُعلقة على الجدار القديم في البيت القديم في الزمن القديم”.
ولهذا، لا أتصور أبدًا أن الشاعر عبد المنعم رمضان قد يكتبُ بغرض التسلية أو تزجية أوقات الفراغ، وإنما المقبول والمعقول- تحديدًا عند عارفيه- أن الرجل مسكونٌ بفراشات المعاني الملونة، التي تأخذ بلبِّه إلى سحابات الغيم المُنطلق، فتهطل أمطار إبداعه سيولًا جارفةً لا تحتجنها جلاميد القديم وسوءاته المكرورة، ولا تُبهره أهازيج الحديث الصَّاخبة وأضواؤه الفاقعة، بقدر ما تكشف كتاباته عن مخبوءاتها في عُري شفيفٍ وجرأةٍ مراوغةٍ، متحديةً أضابير الاتهامات المُعلبة بإثارة الخيال المريض بـ: هيت لك!
يأتي الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2020م، في 373 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ثمانية وأربعين مقالة مُتنوعة، مختلفة الأفانين متفقة الجذور، إذ تدور كلها حول الشعر: “الشعر يزهو بأنه السيد الذي لا سيد له، والشاعر يزهو بأنه ليس الشاعر الداعية، وليس الشاعر التقني الخبير، إنه الشاعر الشامل، الشاعر المشروع، ظل الله وظل الإنسان”؛ هذا المفهوم (الرمضاني للشعر) سيتكرر كثيرًا في باقي مقالاته بمترادفات مختلفة، تدور كلها حول فعالية الشعر وحركته وثوريته: “ولكنني وأنا على مشارف الستين أدرك أن الستين وما بعدها تُعلم صاحبها أن الشعر لا يحتاج إلى صخرة عالية، وأن قصيدة النثر أكثر امتلاء بالشكوك حتى في شعريتها، أقل امتلاء بالزهو حتى في شعريتها، وأن شكوكها اللانهائية هي البوابات الواسعة التي تؤدي إما إلى الخروج إلى الشعر أحيانا، وإما إلى الخروج من الشعر غالبا”.
وهذه الفكرة- مفهوم الشعر وعلاقته بالسلطة- ملحاحٌ عند عبد المنعم رمضان، يكاد ألا يلتفت عنها، ويسعى دومًا إلى سبْر أغوارها بطرق مختلفة، وتُناكشه هي ضمن حكاياته المتعددة بالشعراء المجايلين: “الشاعر الذي يؤمن بالشعر الموزون فقط، شاعر نظام قامع أو مقموع، ومثله الذي يقول بقصيدة النثر فقط، والنظام تنميط، والتنميط حصر، والحصر غش معرفي، والغش هو المرآة السحرية التي تُحب السلطة أن تنظر إليها، وترى من خلالها المكان قزما، والزمان قزما”؛ فالمثقف عنده لا بد أن يكون حُرا بلا كوابح مجتمعية أو أخلاقية، أو أي كوابح أخرى مستترة ومُغلفة بغلاف لامع.
الشاعر النابح
وفي السياق السابق يتحلى عبد المنعم رمضان ليصم نفسه بانه من فئة الشعراء الكلاب، لا من فئة الشعراء الهداهد (جمع هدهد)، الذين مثَّل لهم بمحمود درويش، ففي الوقت الذي افتُتن الهدهد بصورته حين اقترب من النهر فظل هكذا، الفاتن المفتون، ظل الواقف على الحافة، يرى صورته ويدعو كل الآخرين أن يروهما معا، هو والظل؛ فإن الكلب قفز إلى الماء ليهشَّ صورته، ولم ينجح فغرق، وهكذا فعل المتصوفة والحالمون والثوريون والشعراء؛ وهكذا يفعل عبد المنعم رمضان، يُلقي بنفسه في أتون الاعتراضات إلقاء لا هوادة فيه، ولا رعاية لسابق معرفة، لأنه لا مُهادنة في الشعر، ولا هوادة في إبداء الرأي، ولا مُجاملة لمن يعيش في جلباب غيره، ولا لمن يخلع جلبابه ليمشي، أو ليُصلي بالملابس الرسمية في محراب سيده؛ ولذلك فإنه يُقلب كتب الآخرين، تمامًا كما يُقلب كتاب رأسه، ليستخرج لنا الأقوال الحكيمة التي يجب أن نُعلقها على الجدران: “الشعر هو الفن الأكثر ملازمة للثورات في أثناء حدوثها، والأكثر ملاءمة للأزمنة الراكدة في أثناء ركودها، ولأنها الأزمنة الغالبة على تاريخ البشر، فإن الشعر يُصبح لكل الأزمنة”، وهو يُهاجم آراء د. جابر عصفور بجرأة نابحة، ويعبث بكتابه: (زمن الرواية)، يقول: “كنا نعرف أيامها، وقبل أيامها، منذ المنفلوطي وإحسان عبد القدوس، وبعد أيامها منذ علاء الأسواني، أن رواج الروايات يفوق رواج الشعر، وأن وطنًا يحكمه الخراتيت لا بد ان يُعاني من الأمية، ونصف الامية، وبالتالي من الجهل بالفنون الخالصة، الموسيقى الخام، والرسم الخام، والشعر الخام، لكن صاحبنا استطاع أن يقع صُدفة على عبارة أدونيس: (زمن الشعر)، ففهمها فهمًا خاطئا وحوَّرها إلى لافتةٍ باسمه تُناسب مقام الجائزة”؛ وهو يُهاجم حجازي رغم اعترافه بأبوته السابقة له: “وكانت حُروبه ومعارفه هي أنفاقه التي تعثرتُ فيها، اكتشفتُ أن التناسب بين شعريته ونزعة التمرد التي ظلت تنوشه كان طرديا، تشتد وتيرة الشعرية إذا اشتدت وتيرة التمرد”؛ ثم يشتد غضبه على أبيه المخلوع من قلبه حينما يتذكر موقفه من السلطة: “إلا أن هاجس فتى الاستعراض أوقف حجازي على منصة أعدَّها له وزير ثقافته ليخطب خطبة نجاة الديكتاتور في إثيوبيا”؛ ورغم أنه يعترف بأن جهارة شعر عفيفي مطر هي جهارة الأعماق المدعومة بأعمدة النور، فإنه يستدرك بسرعة: “لم نستطع أنا وعفيفي مطر أن نكون قط صديقين حميمين”.
وعبد المنعم رمضان لا يقف مطولا عند محاريب الشعراء القدماء ليُقدِّم لها فروض الولاء، باستثناء إبراهيم عبد القادر المازني، حيث يُقدم عدة مقالات كاشفة عن شخصية المازني (النابحة) أيضًا، الساخرة من كل ما يُحيط بها، لكنه يقرأ ما وراء غيومها: “يُذكرني المازني بأن الطموح بأن تكون حقيقيا، لا يعني تمام اليقين بأن هناك حقيقة ثابتة، الطموح بأن تكون حقيقيا قد يعني سقوط الحقائق تباعا، وظهور حقائق جديدة لا تلبث أن تسقط، إنها المتاهة إذن”.
تعرية الذات
يكتب عبد المنعم رمضان سيرته الذاتية باعتبارها وقائع ناقصة تبدأ من الشعر وتنتهي عنده، فلا ينشغل بالخوف من انكشاف أسراره وظهور عُريها، ولا يخجل من ذكريات قد لا تسكن إلا مخيلته هو، بل يعمد إلى ذلك عمدًا ما دام السياق متقبلا لذلك، ومن ثم لا يسعى لبرهنة أفعاله وتأويلها وتشذيبها ليقبلها المتلقي، يقول في مقالته: (الشعر كل شيء) عن أخته: “لأنني فيما بعد، وايام مُراهقتي، عشقتُها واشتهيتُها، وقرأتُ عليها ذات مرة شعرا مصريا فرعونيا، يُغازل فيه الأخ أخته، ولأنني ذات مرة قبَّلتها في فمها”، ويعود ليقول في المقالة نفسها: “إنني أُمسك بالحُلم الذي يُعرِّي أختي، ويصب ردفيْها ونهديْها في حِجري”؛ ثم يقول في المقالة التالية: (الحلم ظل الوقت- الحلم ظل المسافة): “وأتخيل نفسي أقابل امرأة تخرج من كهف، وتسير بجانبي، ونكتشف فجأة أننا تائهان في صحراء، وأنها تغويني، وعندما أبكي تمسح دموعي وتخبرني أن أمصَّ نهديها، ومن مذاقهما الحارق أعرف أنها أختي”، وهو خيال مارق من التأطير المجتمعي والديني، وأعتقد أنه مارقٌ أيضًا من الحدود الإنسانية والذوقية، وأن عبد المنعم رمضان لم يكن موفقا فيه، فقد خانته شاعريته وخذلته حُريته، تمامًا مثلما خذله رأيه السياسي المدسوس بين الكلمات، حيث يُصر على تسمية الجيش المصري الوطني (بالعسكر)، بما تحمله الكلمة من دلالات مرذولة وغير مقبولة لدى جموع الشعب، وكذلك رأيه في نصر أكتوبر: “كنا مُلوثين بصدأ نكسة 67، وبعض النصر الناقص، الأصح: النصر المهزوم في أكتوبر 1973”.

[ad_2]


